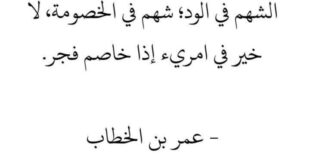كيف صُنِع الخميني ليُدير فوضى الشرق الأوسط حتى اليوم؟
في السياسة لا توجد “مصادفات بريئة” حين يتعلق الأمر بتغيير أنظمة كبرى…
ولا توجد ثورات تهبط من السماء بلا سلالم. ..
ما حدث في إيران أواخر السبعينيات لم يكن مجرد سقوط شاه وصعود رجل دين، بل كان نقلا محسوبا للسلطة من أداةٍ انتهت صلاحيتها إلى أداةٍ أكثر ملاءمة للمرحلة القادمة.
ومن يقرأ الوثائق التي بنيتُ عليها مقالاتي والتي سيتم نشرها حين أنشر كتابي، يدرك أن الخميني لم يكن حادثة، بل مشروعا…
وأن “نويل لوشاتو” لم تكن قرية فرنسية هادئة، بل “مسرحا” تم فيه تركيب الزعيم على مقاس الحاجة الدولية…
قد يبدو هذا الكلام صادما لمن لا يزال أسير السردية الرومانسية عن “ثورة المظلومين”، لكن التاريخ حين يُقرأ من زاوية المصالح لا من زاوية الشعارات، يفضح نفسه بنفسه….
فالسؤال الحقيقي ليس: لماذا سقط الشاه؟ بل:
لماذا اختير الخميني تحديدا؟
ولماذا فُتحت له فرنسا، التي يفترض أنها تمنع النشاط السياسي على أراضيها، كل الأبواب ليحوّل قرية نائية إلى مركز بث عالمي؟
الحقيقة بوضوح:
الشاه لم يُخلع لأنه عدو لأمريكا، بل لأنه خرج قليلا عن الدور…
– بدأ يبني جيشا قويا
– لوّح بشراء السلاح من السوفييت
– رفع سقف النفط
– وأغلق بؤر توتر كانت واشنطن تفضّل إبقاءها قابلة للاشتعال…
*وهنا تتجلى القاعدة التي تلخّص سلوك الإمبراطوريات:
إنها لا تُسقط خصومها أولا، بل تُسقط أدواتها حين تظن أنها أصبحت “دولة” لا “وظيفة”.
يقول هنري كيسنجر – بواقعية جارحة – إن الدول الكبرى لا تُكافئ على الوفاء بل على المنفعة….
وهذه ليست قسوة شخصية منه، بل توصيف لنظام عالمي يخلع الحلفاء كما يخلع القفازات حين تتسخ….
الشاه كان قفّازا مفيدا، ثم صار قفّازا مُقلِقًا خادِشا للبشرة الأمريكية الحساسة !
وهنا يبدأ الجزء الأكثر ذكاء في السيناريو:
لم يكن المطلوب استبدال الشاه بخصم قوي مستقل، بل ببديل قادر على توليد فوضى طويلة المدى، دون أن يقطع الخيط مع الغرب بالكامل…
لذلك لم يكن الخيار ضابطًا قوميًّا قد يقود انقلابا وطنيا يخرج من بيت الطاعة،
ولا يساريا قد يرتمي في حضن موسكو،
ولا ليبراليًا ضعيفًا بلا شارع…
** الخيار كان رجل دين، لأن رجل الدين لا يحتاج برنامجا اقتصاديا ولا رؤية مؤسساتية كي يحكم، يكفيه أن يمتلك “قداسة” ترفع المساءلة عنه، وأن يمتلك “شارعا” يحميه بالغضب.
في تجربة مصدق عام 1953، تعلمت وكالة المخابرات المركزية الدرس الأهم: رجال الدين هم المفتاح الأسرع لعقل الجماهير…
حين فشل الانقلاب الأول، لم تنقذ الـCIA خطتها بالدبابات، بل أنقذتها بتفعيل شبكة رجال الدين وشراء الذمم بالأموال، ثم دفع الشارع للانقلاب على مصدق…
هذه ليست رواية، بل نمط متكرر: المال + المنبر + الشارع = انقلاب ناجح.
ولهذا، حين أرادت واشنطن التخلص من الشاه، لم تذهب إلى الأحزاب، ولا إلى النخب، بل ذهبت مباشرة إلى رجال الدين….
لم تكن مهتمة بمن “يكرهها” في خطابه، بل بمن يستطيع أن يضبط الجماهير ويحوّل السياسة إلى طقس ديني، لأن الطقس لا يُناقش.
وهكذا استيقظ الخميني من نومته الطويلة في النجف….
لم يُنقل إلى بلد إسلامي قريب، بل أُخرج عبر مسرحية الحدود، ثم حُمل إلى فرنسا. ومن المفترض أن فرنسا اشترطت عليه ألا يمارس نشاطا سياسيا، لكن ما حدث هو العكس تماما:
– تحولت “نويل لوشاتو” إلى خلية نحل إعلامية تعمل أربعا وعشرين ساعة…
وكأن العالم كله اكتشف فجأة أن رجلا في قرية فرنسية يستحق أن تُنصب له أبراج بث، وأن تُفتح له الإذاعات، وأن تتسابق الصحف إلى نقل كلماته.
هذا ليس دعما لثائر، بل تصنيع لرمز.
يقول “جورج أورويل”:” إن من يملك القدرة على تشكيل اللغة يملك القدرة على تشكيل الوعي”.
والخميني لم ينتصر بالسلاح في البداية، بل باللغة التي صيغت له، وبالصورة التي رُسمت عنه….
صار “قائدا”، لا لأنه الأكثر علما أو الأكثر حكمة، بل لأنه الأكثر قابلية لأن يُختزل فيه المشهد كله.
وهنا جاءت لحظة الخداع الكبرى: تم تلميع رجلٍ ديني على أنه “صوت الشعب”، بينما القوى السياسية الأخرى كانت أكثر تنظيما وحضورا.
الأكثر سخرية أن موجة التلميع لم تقتصر على الإعلام، بل شارك فيها فلاسفة كبار مثل “ميشيل فوكو” و “سارتر” و “سيمون دي بوفوار”…!!
-فوكو، الذي كان يفترض أن يرى آليات السلطة، وقع في غواية “الثورة الروحية”، ثم اعتذر لاحقًا بعد أن رأى الدم…
لكن الاعتذار المتأخر لا يغيّر حقيقة أنه ساهم في تسويق الأسطورة. ..
وهنا نفهم معنى قول “هانا آرندت”:
” إن أخطر ما في الأنظمة الشمولية ليس أنها تكذب، بل أنها تجعل الناس يعتادون الكذب حتى يصبح هو الواقع”!
وحين عاد الخميني إلى طهران، لم يبدأ ببناء دولة، بل بدأ بتصفية الشركاء…
لأن الأنظمة المصنوعة لا تسمح بتعدد الرؤوس….
تخلص من رجال المرحلة:
يزدي، قطب زادة، أبوالحسن بني صدر، ثم جاء الدور على الرقم الأصعب: بهشتي.
هذا النمط ليس عشوائيا، بل قاعدة:
كل من ساعد في الصعود يصبح خطرا بعد الوصول.
ثم جاءت مسرحية الرهائن، التي تشير الوثائق المعتبرة إلى أنها لم تكن مجرد فعل ثوري ضد أمريكا، بل ورقة داخل الانتخابات الأمريكية بين “كارتر وريغان”.
هنا يتجلى جوهر الخمينية:
-عداء معلن يرفع الشعبية
-وتفاهمات عميقة تحفظ الوظيفة….
** والوظيفة كانت واضحة: صناعة خصم إقليمي دائم، يُخيف الخليج، ويستنزف العراق، ويؤسس لصراع مذهبي طويل، ويجعل المنطقة كلها تحتاج “وسيطا دوليا”
لا يختفي أبدا ..
ومن هنا يصبح الربط مع اليوم واضحا دون عناء….
ما يحدث في الإقليم الآن ليس “انفلاتا” من الماضي، بل امتداد مباشر له…
إيران اليوم، بوجه خامنئي أو من سيأتي بعده، ليست مشروع دولة طبيعية، بل مشروع نفوذ قائم على الوكلاء….
هي لا تحتاج أن تنتصر عسكريا بقدر ما تحتاج أن تُبقي النار مشتعلة….
لأن النار حين تنطفئ، يعود السؤال الذي يخافه كل نظام عقائدي:
ما شرعيتك في الداخل؟ ولماذا ندفع نحن فاتورة مشاريعك؟
لهذا، فإن المستجدات في إيران اليوم ليست مجرد أزمة اقتصادية أو احتجاجات اجتماعية، بل هي بداية تصدع في المعادلة:
الشعب الإيراني لم يعد يرى ؛الثورة”، بل يرى الفاتورة….
يرى أن الخمينية تحولت إلى طبقة امتيازات
وأن الحرس الثوري صار دولة داخل الدولة
وأن العقيدة صارت وسيلة ضبط لا معنى….
وهذا أخطر ما يواجه الأنظمة: حين يفقد الناس الإيمان، لا يبقى إلا الخوف، والخوف لا يبني مستقبلا.
الخميني إذًا لم يكن نقيض الشاه، بل كان البديل الأنسب لإدارة مرحلة جديدة:
مرحلة فوضى محسوبة، وصراع طويل، وتوازن نزيف. ..
واليوم، حين ننظر إلى الخرائط المشتعلة من العراق إلى سوريا إلى اليمن، لا نحتاج كثيرا من الذكاء لنفهم أن الخمينية لم تكن حدثا إيرانيا داخليا فقط، بل كانت إعادة هندسة للشرق الأوسط.
أكرر الخلاصة التي يجب أن تُقال في نهاية كُل مقالة و ببرود:
الخميني مات، لكن ما صُنع له لم يمت….
لأن الأنظمة لا تعيش بالأشخاص، بل بالوظائف….
وحين تنتهي الوظيفة، يسقط الرمز، ولو بقيت صورته معلقة على الجدران.
 إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة
إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة