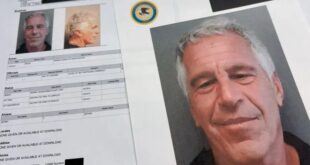أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018 عقدت في الكويت قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عرفت باسم قمة “اليوم الواحد” في أجواء أزمات متراكمة تعصف بالمنطقة عموما، ومنطقة الخليج بشكل خاص.
لا تزال الأزمات ذاتها، بل أنها تفاقمت في حدتها وباتت عصية على الحل بدءا من أزمة الحرب الأهلية في اليمن ومرورا بالأزمة القطرية وانتهاء بالمواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي في مجملها أزمات متداخلة.
تشكل هذه الأزمات تهديدا جديا على بقاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
في القمة الخليجية التي استضافتها الكويت، صدر عنها “إعلان الكويت” إدراكا منها لخطورة ما يواجهه مجلس التعاون كمنظومة، ودوله من تهديدات وتحديات.
وجه “إعلان الكويت” إنذارا لتلافي الأخطار المحدقة بمنظومة المجلس موصيا بأهمية “التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي عن تداعياتها”.
كما شدد الإعلان على “أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف دفاعا عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح”.
كانت الغاية من إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوائل ثمانينيات القرن الماضي تحسين الأمن الجماعي والوقوف على أرضية مشتركة في مواجهة التحديات للدول الست التي تحكمها عوائل تتوارث الحكم تلتقي على عرقية عربية مشتركة وهوية “سُنيّة” واحدة في مواجهة تهديدات “تصدير الثورة الإيرانية” التي تقود العالم الشيعي.
ويهدف مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولا إلى الوحدة فيما بينها.
تشكل الانقسامات داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي “عقبة” في الوصول إلى مشتركات مجمعٌ عليها بين الدول الست التي تباينت مواقفها وفق الاستقطابات الداخلية إلى محور يضم السعودية والإمارات والبحرين، في حين تبدو قطر منفردة، بينما تقف سلطنة عمان ودولة الكويت في نقطة يحاولان الانطلاق منها للتوصل إلى مشتركات يلتقي عليها طرفا الأزمة في سبيل حلها وإعادة التماسك إلى بنية المجلس.
ويبرز الموقف من إيران المسألة الأكثر تعقيدا بين الدول الست داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومع أن دول المجلس بشكل عام ترى أن إيران تشكل تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها، إلا أن كل دولة من الدول الست تقع ضمن دائرة الاستقطابات الداخلية، ما يحول دون بناء موقف موحد؛ وتحتفظ كل دولة على انفراد بموقف خاص بها وفق ظروفها الداخلية وتركيبة مجتمعها الذي يضم عادة نسبة من الشيعة، أو العلاقات الاقتصادية مع إيران وعوامل أخرى.
وتقف السعودية في مقدمة الدول الست في ما يمكن تسميته بـ “العداء” لإيران وتتضامن معها البحرين بشكل خاص لاعتبارات تتعلق بالتهديدات الداخلية “المفترضة” من قوى وشخصيات حليفة لإيران، والإمارات إلى حد ما مع النظر بعين “فاحصة” إلى حجم التعاملات التجارية مع إيران وأثرها على طبيعة العلاقات بينهما، في حين تقف كل من سلطنة عمان، ودولة الكويت إلى حد ما، مع الإبقاء على علاقات ودية نسبيا مع إيران تزداد عمقا مع دولة قطر التي تضع في أولوياتها مواجهة تحديات المقاطعة الرباعية وحاجتها إلى إيران التي تتشارك معها في أكبر حقول الغاز في العالم.
كما أنّ مجلس التعاون بدا وكأنه منقسم على ذاته إلى محورين يضم الأول محور دول المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين؛ أما المحور الآخر فيضم قطر والكويت وسلطنة عُمان؛ وهي حالةٌ غير مسبوقة في تاريخ منظومة مجلس التعاون.
في مقابل ذلك، يتم تعزيز التحالفات الثنائية بين الأعضاء في الدول الست دون بناء تحالف مشترك يضم الجميع؛ وهي تحالفات يُنظر إليها في أحيان كثيرة على أنها بديل عن العمل المشترك داخل مجلس التعاون الخليجي، وأنها تعزز الانقسامات المجتمعية بشكل أكبر.
وتُعد حالة الانقسام المجتمعي الراهنة، التحدي الأكثر خطرا في تاريخ مجلس التعاون لانتقاله من الانقسام والخلافات بين أنظمة الحكم الستة إلى انقسام حاد بين شعوبهم حول الموقف من أزمة قطر، أو الأزمة اليمنية التي تجر تباعاً إلى الموقف من إيران والتصعيد المتبادل مع المملكة العربية السعودية.
في كل الأحوال أضرت الأزمة القطرية بسمعة الدول الست على المستويين الإقليمي والدولي، كما أن الأزمة أفصحت عن إمكانية تراجع ثقة الغرب بدول المجلس كشركاء أمنيين موثوق بهم؛ في الوقت ذاته، أثبتت الأزمة عجز الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عن لعب دور فاعل لحل الأزمة بين دول حليفة لها تستضيف أكثر من دولة منها قواعد عسكرية، من بينها دولة قطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط.
في مقابل ذلك، لا توجد مؤشرات حقيقية على رغبة دول المقاطعة في حل الأزمة مع الإقرار بتمسك طرفيها بمواقفهم المعلنة منذ بدايتها، حيث تتمسك دول المقاطعة بعدم القبول بأي حل دون استجابة قطر لشروطها، وهو ما ترفضه دولة قطر التي ترى فيها نوعا من أنواع “الوصاية” وانتهاك السيادة والتدخل في شؤونها، مفضلة حل الأزمة عبر حوار ثنائي يضع أسس لعلاقات مستقبلية سليمة مع تلك الدول.
ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى احتمالات انتهاء الأزمة الخليجية في الأجل القريب طالما ظل طرفا الأزمة يتمسكان بمواقفهما دون تقديم تنازلات متبادلة؛ لكن هذا قد يدفع صناع القرار في المجتمع الدولي للعب دور أكبر في تخفيف حدة الأزمة التي قد تتطور إلى صراع إقليمي لا يخدم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما أن استمرار الأزمة سيؤدي حتما إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة مع تقاعس قوى دولية تمتلك ما يكفي من أوراق الضغط على طرفي الأزمة بلعب دور جدي في فرض تسوية مقبولة من طرفي الأزمة، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
في مقابل ذلك، ليس ثمّة ما يؤكد على انهيار قريب لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو عودة التماسك إليها؛ في حين يبدو أن هذه المنظومة قادرة على الاستمرار دون فاعلية في الأداء أو التأثير في العلاقات البينية بين الدول الست الأعضاء، أو علاقات دول المنظومة مجتمعة مع الدول والتكتلات السياسية الأخرى.
من المرجح أن يستمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية كهيكل قائم يعقد اجتماعاته الدورية على مستوى مجلس القمة أو مستويات أدنى، في حين سيتضاءل دوره الإقليمي والدولي كمنظومة متعددة الأطراف في ظل اتجاه طرفي الأزمة إلى بناء تحالفات ثنائية خارج إطار المنظومة، السعودية مع الكويت والإمارات، ودولة قطر مع تركيا وإيران، وتحالفات أخرى أقل أهمية وتأثيرا.
 إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة
إحسان الفقيه زاوية إخبارية متجددة